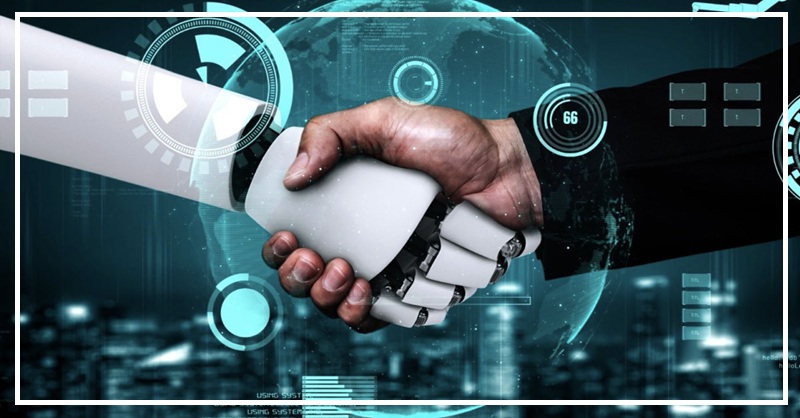- بيت شباب الإسماعيلية يستضيف منتخب زامبيا للهوكي
- "القسام": سنسلم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما اليوم
- يبراميدز يتوج بالسوبر الإفريقي لأول مرة على حساب نهضة بركان
- الشيباني: مراجعة الاتفاقيات السابقة مع روسيا ومفاوضات حول القواعد العسكرية
- سيدات الأهلي إلى نهائي إفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على فاب الكاميروني
النوبل تُمنح بالأصوات.. أما قلادة النيل فتُمنح بالتاريخ
في حياة الأمم مشاهد لا يصنعها التاريخ، بل تصنع هي التاريخ.
ومن بين تلك الوقائع ما شهده العالم في شرم الشيخ، حين قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة النيل العظمى إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كان مشهدًا من تلك اللحظات التي يكتبها النيل بروح التاريخ لا بقلم السياسة.
كانت المدينة بين البحر والصحراء تتنفّس سلامًا، وكأنها تُعيد تعريف القوة: بأن تقدر فلا تظلم، وأن تملك فلا تتجبّر، وأن تُكرّم لا لتُجامل، بل لتُعبّر عن معنى أعمق من السياسة… إنه معنى الامتنان لمن شارك في صناعة السلام لا في فرضه.
لم تكن القلادة مجرّد وسامٍ على صدر رجل، بل كانت رمزًا يُضيء مسار الشراكة بين دولتين: بين وادي النيل الذي علّم العالم معنى الحضارة، والبيت الأبيض الذي يصنع قرارات العالم.
ولأن قلادة النيل كانت دومًا مرآةً تعكس وجه مصر أمام العالم، ففي تلك اللحظة لم تكن مصر تُكافئ شخصًا، بل تُكرّم فكرة — فكرة أن السياسة يمكن أن تكون جسرًا لا جدارًا، وأن الزعامة لا تُقاس بما تملكه من جيوش، بل بما تتركه من أثرٍ في وجدان الشعوب.
عرف العالم ترامب رجل الصفقات، بينما رأته مصر رجل المواقف؛ فحين كانت المنطقة على حافة الانفجار، اختار لغة الحوار بدلًا من ضجيج البنادق، مؤمنًا بأن الشرق الأوسط لا يهدأ إلا إذا بقيت مصر قوية، صامدة في منتصف الخريطة، تمسك الميزان بيدٍ من حكمةٍ ويدٍ من حزم.
ولهذا جاء التكريم مصريّ الطابع، دافئ النبرة، بعيدًا عن حسابات السياسة قصيرة المدى.
ومصر لا تُكرّم كثيرين، لكنها حين تفعل تُنصِف التاريخ.
فمن قبل ترامب، حمل جيمي كارتر القلادة نفسها — لا لأنها من ذهبٍ، بل من أجل تقديرٍ صادق.
كرّمته مصر ليس فقط لأنه وقّع معاهدة السلام، بل لإيمانه أن السلام يمكن أن يُوقّع بالمشاعر قبل القلم.
وبعده، حملها الملك سلمان بن عبد العزيز، والملكة إليزابيث الثانية، ونيلسون مانديلا، وكأن القلادة نفسها تُعلّق على عنق الإنسانية كلما لمست مصر روحًا تشبهها في نقائها وكرامتها.
إنّ قلادة النيل ليست وسامًا يُمنح، بل رسالة تُقرأ.
هي ليست قطعةً معدنيةً تتلألأ في الضوء، بل معنى يُضيء التاريخ.
إنها تقول ببساطة: «منحناك من نيلنا قطرةً، لأنك سقيت معنا أرض السلام.»
ولهذا لا تُقاس قيمتها بثمنها، بل بمدى صدقها.
فـ نوبل تُمنح بالأصوات، أما قلادة النيل فتُمنح بالأثر.
النوبل قرار لجنة، أما القلادة فقرار وطنٍ كامل، وطنٍ يرى بعين الضمير أكثر مما يرى بعين الحساب.
ولعلّ المفارقة الأجمل أن ترامب الذي تمنّى يومًا جائزة نوبل للسلام، وجد نفسه أمام تكريمٍ لا تمنحه لجنة، بل حضارة.
وليس غريبًا أن تولد مثل هذه اللحظة في شرم الشيخ، المدينة التي تصالحت فيها الرمال مع البحر، والعقل مع العاطفة.
فمصر لا تصنع الأحداث فقط، بل تصنع رموزها، وتختار بعناية من يعلّقون في ذاكرة نيلها.
على مدى التاريخ، لم تكن مصر تملك الذهب أكثر من غيرها، لكنها كانت تملك ما هو أثمن: فملكت القدرة على أن تُكرّم دون أن تتنازل، وأن تُعطي دون أن تُدين، وأن تُعلّم العالم أن العظمة لا تُقاس بما تأخذه، بل بما تمنحه.
وهكذا، حين امتدّ النيل بمعناه نحو قصر المؤتمرات في شرم الشيخ، كان المشهد أكبر من الاحتفال.
كان درسًا جديدًا في الدبلوماسية المصرية: بأن التكريم ليس ضعفًا، بل تأكيدٌ على الثقة بالنفس، وأن الدولة التي وهبت الدنيا أول حرف، تعرف جيدًا متى تكتب جملتها الأخيرة.
فـ مصر — منذ فجرها الأول — لا تعرف السياسة الباردة، بل تصنع الدفء حتى في أوقات الجليد.
هي لا تُكافئ بالمعدن، بل بالمعنى.
لا تحمل السيوف لتغزو، بل تحمل النيل لتُحيي.
وحين تمنح قلادتها، فهي تمنح شيئًا من روحها، من مجدها، من تاريخها الذي لا يصدأ.
ولهذا سيظل المشهد في شرم الشيخ شاهدًا على لحظةٍ مصريةٍ خالدة…
لحظةٍ أثبتت فيها مصر أن التكريم عندها ليس فعلاً سياسيًا، بل إيماءة حضارية تقول:
«قد تختلف الأزمان، لكن يبقى النيل هو من يمنح الخلود.»