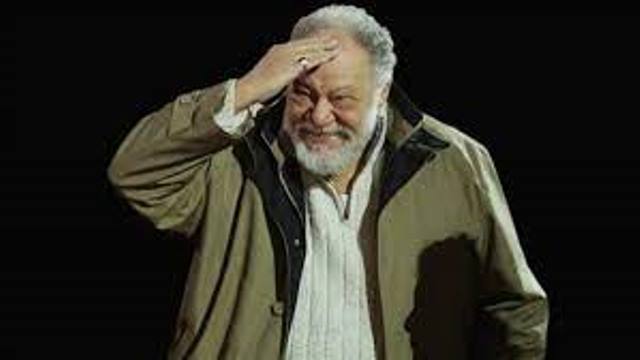رؤى فلسفية
«الاستشارة الفلسفية».. من خاب من استشار (1 – 2)
ماذا تعني الاستشارة الفلسفية أو العلاج الفلسفي؟ وهل هناك فرق بين العلاج الفلسفي والعلاج النفسي؟ أو بين الاستشارة الفلسفية والاستشارة النفسية؟ ومن هو المستشار الفلسفي؟ لكن، قبل أن نشرع في الإجابة عن هذه التساؤلات، نبدأ بعبارات موجزة نُلخص بها الدور الحقيقي والمقصود من الفلسفة. وخير ما نستند إليه في هذا السياق ما ذهب إليه ريكمان – أستاذ الفلسفة في بريطانيا – حين وضع منهجًا للدراسات الفلسفية، فقال:
"الواجب العام للفلسفة يتمثل في بناء أنماط تصورية تفسّر الخبرة وتوضّحها، وأن التحليل الدقيق يجب أن يسبق هذا البناء، بل أن يكون متضمَّنًا في كل عملية تفلسف. نحن نُحلل التصورات لنكتشف معانيها، ونفحصها للوقوف على صدقها، وندرك أبعادها".
أضف إلى ذلك، عزيزي القارئ، أن الفلسفة ينبغي أن تواصل دورها الرائد في ميدان الأفكار، ولا يصح أن يُتَّهَم الفيلسوف بأنه يجلس في انتظار ما يُقدَّم إليه من أفكار واقتراحات، ليقوم بعد ذلك إما بنقدها أو بتفسيرها. فإسهام الفيلسوف ليس نوعًا من الوحي، بل عليه أن يتعلم أولًا مما يفعله الباحث، وأن يُدرك المشكلة إدراكًا عميقًا، ثم يستخدم مهاراته الخاصة لبيان القيمة العملية لفلسفته. وهذا يقتضي أن تكون معالجة الفيلسوف موجَّهة نحو المشكلات الواقعية المستمدة من الحياة اليومية.
إن الفلسفة، بهذا المعنى، هي "فنّ العقل"، أما الفيلسوف فهو "فنّان العقل"، شريطة أن نفهم "الفن" بمعناه الدقيق، بوصفه الأداة أو الوسيلة التي تُشيِّد منظومة متكاملة من المقولات والمفاهيم. فالفلسفة هي الميل الطبيعي والروحي نحو التحلي بالحكمة، أما الفيلسوف فهو "محب الحكمة". ومن هنا، تتجلى مهمة الفلسفة في إرساء علاقة متماسكة بين مختلف أنماط المعارف، وبين الغايات الجوهرية للعقل البشري. وهذا ما أكده الأكاديمي الفرنسي بيير هادو حين قال: "الفلسفة، بالمعنى العريق للكلمة، ليست بناءً لمجرد منظومة مفهومية، بل هي طريقة في العيش".
كما قدّم لنا الأكاديمي وعالم النفس الألماني إريك فروم تصورًا عن المجتمع السليم في ضوء معيار الصحة العقلية، حيث يقول:
"إن المجتمع قد يكون سليمًا، وقد يكون مريضًا، ولهذا مقاييس محددة ومعروفة. ومن هنا، فإن مشكلة الوجود الإنساني – غربة الإنسان في الكون، ووحشته في الوجود، وتفرّده بسيكولوجية خاصة تميّزه عن سائر الكائنات – تفرض علينا الاعتراف بوجود حلول صحيحة وأخرى خاطئة، حلول تُشبع حاجات النفس وأخرى تعجز عن ذلك.
وتتحقّق الصحة العقلية حين ينجح الإنسان في أن يتطوّر إلى أقصى درجات النضج، وفقًا لمقوّمات الطبيعة البشرية وقوانينها. ويصاب بالمرض العقلي إذا عجز عن هذا التطور. وعلى هذا الأساس، فإن معيار الصحة العقلية لا يكمن في التوافق مع نظام اجتماعي معين، بل هو معيار إنساني شامل ينطبق على البشر جميعًا. إنّه البحث عن حلّ مُرضٍ لمشكلة الوجود الإنساني، حلّ يكفل للمجتمع الانسجام مع الطبيعة، ويُبعد القلق عن النفوس، ويُعيدها إلى صلتها الأصيلة بالطبيعة التي انفصلت عنها، فتبعث فيها الطمأنينة والسكينة".
وأستطيعُ – بإيجاز، عزيزي القارئ – أن أقول إن فكرة الصحة العقلية تنبع من ظروف الوجود البشري ذاتها، وهي ثابتة في جوهرها عبر العصور والثقافات. وتتميّز هذه الصحة بالقدرة على الحب والخلق، وبالتحرر من الارتباطات الأولية بالقبيلة أو الأرض، وكذلك بالإحساس بالذات، حيث يدرك المرء نفسه بوصفها أداة لتوظيف قواه وقدراته. كما تتجلّى الصحة العقلية في إدراك الواقع، سواء داخل النفس أو خارجها، أي في نضج العقل، وترسيخ النظرة الموضوعية.
ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكننا – وفقًا لما يطرحه إريك فروم – أن نصل إلى هذا المجتمع السليم عقليًا، أملًا في تحقيق الانسجام المنشود بين الإنسان والبيئة من حوله؟
صديقي القارئ، إن أي نظام اجتماعي أو سياسي لا يتعدّى أثره أن يُعزّز أو يُعيق قيمًا ومُثلًا عُليا قائمة بالفعل بين أفراد المجتمع. إن المُثل العليا التي تُنادي بها الأديان السماوية – الإسلام والمسيحية واليهودية – لا يمكن أن تتحوّل إلى حقائق واقعية في مدينة مادية، يُشكّلها منطق الإنتاج والاستهلاك والنجاح في السوق. ولا يمكن، من ناحية أخرى، للاشتراكية الصحيحة أن تُحقّق أهداف الأخوة والعدالة والفردية، ما لم تكن الثقافة السائدة بين أفراد المجتمع قادرة على استيعاب هذه الأهداف وتقبُّلها.
ولن يستطيع أي مجتمع – مهما بلغ من درجات الثراء والتقدُّم – أن يصل إلى مرحلة الفهم الصحيح والسليم، دون الاعتماد على الفلسفة؛ فحتى هذه المرحلة تتطلّب تفكيرًا فلسفيًا. وهنا يتجلّى الدور الحقيقي للفلسفة. ويبقى السؤال المطروح: هل يُمكن لهذا الدور أن يُمكّننا من عيش حياة أكثر هدوءًا ونقاءً؟ والجواب: نعم، بالطبع، إذ يُمكن للفلسفة أن تكون خير معين لنا في هذه الحياة، إذا طُبِّقت فعليًا في صورة من صورها، وهي: الاستشارة الفلسفية.
إن الاستشارة الفلسفية هي التطبيق الفعلي لممارسة الفلسفة في الحياة، وذلك من خلال اتصالها بمشكلات الحياة اليومية، وكأداة فاعلة لمساعدة الفرد على إضفاء معنى على وجوده. وهذا ما نقلَه إلينا الدكتور سامح طنطاوي عن الأكاديمي الألماني أشينباخ.
كما قدَّم لنا ران لاهاف، الأكاديمي الأمريكي، مفهومًا مُبسّطًا للاستشارة الفلسفية في ثلاث نقاط موجزة: ما الحياة إلا عمليةُ تفسيرٍ لأنفسِنا وللعالم (تأويل رؤية العالم)، والاستشارة الفلسفية توفّر بيئةً منضبطةً وموجَّهة للانخراط في تأويل أنفسنا وتأويل العالم. إذًا، فالاستشارة الفلسفية تقدِّم عونًا في الحياة.
ولكن، هل العلاج الفلسفي أو المشورة الفلسفية شيءٌ مُستحدَث، أم أنه كان موجودًا من قبل؟ إجابتنا عن هذا التساؤل ستكون موضوع مقالنا القادم، إن قدّر الله لنا البقاء واللقاء.
[email protected]