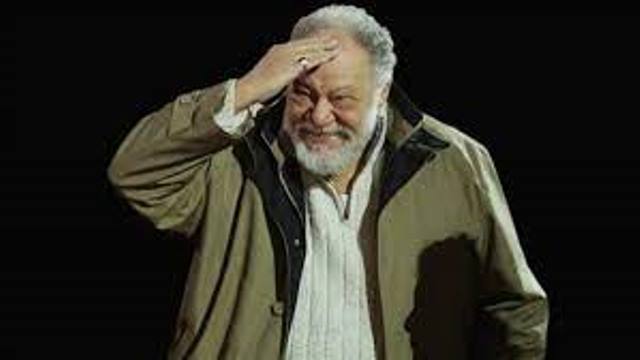رؤى فلسفية
أفلاطون يُبعث من جديد
حين تتواطأ اللغة مع الذوق، ويجتمع صدق الترجمة مع عبق النص الأصلي، نكون أمام مترجم لا يكتفي بنقل الكلمات، بل يُعيد بعث الروح في جسد آخر. هذا العمل لم يكن مجرد جسر لُغَوي بين ثقافتين، بل كان ولادة ثانية للنص، تحمل نبضه الأول وحرارته الكامنة، وقد أخرجه لنا هذا المترجم بمهارة الصائغ وشفافية العاشق.
أكتب إليكم، أعزاءي القراء، عن ترجمة جديدة لإحدى محاورات أفلاطون، وهي محاورة كراتيلوس في "فلسفة اللغة". وهذه الترجمة ليست مجرّد نقل من لغة إلى أخرى، بل بعثٌ جديد لنصٍّ أدبيٍّ تنفّس بلغة الضاد، حتى ليبدو وكأنّه وُلِد بها. وقد قدّم لنا هذه الترجمة الأستاذ الدكتور محمد جمال الكيلاني، أستاذ الفلسفة اليونانية وفلسفة العصور الوسطى بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس. صدرت هذه الترجمة عن دار صفحات للدراسات والنشر، في العام الحالي 2025م، ويقع الكتاب في مئتين وثماني وستين صفحة.
وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء رئيسية، أولًا: مقدمة المترجم، وتشمل: نشاه اللغة اليونانية ولهجتها، فلسفه اللغة عند افلاطون، بنيه التحليل اللغوي في محاوله كراتيلوس، ترجمات محاوره كراتيلوس والدراسات حولها، تحليل مجدي لمحاوله كراتيلوس، منهجيه الترجمة الحالية والمصطلحات اليونانية الواردة فيها، وصول ومعنى اسماء الهه اليونان. ثانيًا: مقدمه بنيامين جويت. ثالثًا: النص اليوناني لمحاورة كراتيلوس. رابعًا: ترجمه محاوره كراتيلوس «في فلسفة اللغة».
ينقل لنا الكيلاني في هذا الكتاب رؤيةً تكشف عن استكشاف أفلاطون لإمكانية ترسيخ المعاني، لا في الأشياء المثالية المتعالية، بل في الممارسة اللغوية وفي العلاقة بين الكلمات والأشياء المادية. إذ ينطلق سقراط ومحاوره في محاولة الكشف عن طبيعة العلاقة بين الكلمة وماهيتها، بما يتضمن أن تكون الكلمة أداةً ملائمة لتصوّر الشيء الذي تشير إليه. وينبغي، تبعًا لذلك، أن يكون معنى الكلمة تجسيدًا لطبيعة الكائن الذي تدل عليه. ويُجرى هذا التحقيق أولًا فيما يتعلق بالأشياء الموجودة في العالم المادي: الكلمات، والمعاني اللغوية، والعلاقات بين الكلمات والكيانات المادية التي تسميها أو تصفها. وتقتصر المعايير الحاكمة لهذا التحقيق على اشتراط أن تكون الكلمة أداة دقيقة في تقسيم الواقع.
واستطرد مضيفًا أن اهتمام أفلاطون الدائم بالتعريف لم يكن نابعًا من رغبة في التعريف لذاته، بقدر ما كان وسيلة لتوضيح المعنى. فلكي يكون المعنى نافعًا كأداة للمعرفة، ينبغي ـ بحسب أفلاطون ـ أن يُعبّر عن طبيعة حقيقية. وتكمن القيمة الأساسية للّغة في كونها أداة لفهم العالم كما هو. أما إذا كان العالم غير مستقر بما يكفي، كما يرى أصحاب مذهب "ثياتيتوس" أو "كراتيلوس"، فإن اللغة تفقد فاعليتها كأداة للمعرفة.
وتوالت عباراته لتكشف أن كراتيلوس يخلص في نهاية المطاف إلى أن الفهم غير اللغوي للواقع أمر ضروري لتحديد المعاني. وهذا الحدس ذاته هو ما يدفع بالحجج في "الجمهورية" و"المأدبة" إلى السعي نحو ارتقاء معرفي، يتم من خلاله تجاوز الفهم القائم على اللغة نحو إدراك نماذج مجرّدة، يُفضي تأملها إلى فهم أعمق للمفاهيم، بحيث يتجاوز هذا الفهم أسسه اللغوية. وبهذا التحول، يغدو المفهوم اللغوي مفهومًا صالحًا من الناحية المعرفية. وتُعدّ مثل هذه المفاهيم ضرورية لتحقيق المعرفة الحقيقية.
يدور حوار "كراتيلوس" بين موقفين متعارضين، يتوسطهما سقراط بوصفه صوتًا ثالثًا ووسيطًا فلسفيًا. إذ يرى "هيرموجينيس" أن الأسماء صحيحة تمامًا من خلال التقليد (syntheke)، أي أنها نتاج اتفاق أو مواضعة لغوية، ويمكن اختيارها بشكل اعتباطي طالما أن استخدامها يظل متّسقًا مع بعض الأعراف والتقاليد المحددة.
أمّا "كراتيلوس" (المحاور الآخر) فيمثل النزعة الطبيعية المتطرفة، وهي وجهة النظر القائلة إن جميع الأسماء تصف بدقة الأشياء التي تشير إليها، وأن لكل شيء اسمًا طبيعيًا ملائمًا لطبيعته. ويؤدي سقراط في هذا الحوار دور الوسيط الفلسفي بين الطرفين. وخلال مجريات الحوار، يبيّن سقراط أن أياً من النظريتين لا يقدم وصفًا دقيقًا ووافياً للعلاقة بين الأسماء والأشياء. وتتمثل وجهة نظره الخاصة في أن اللغة ليست موضع ثقة مطلقة، وأن المعرفة الحقيقية لا تُستقى من الألفاظ أو الصور، بل من الأشياء ذاتها كما هي في حقيقتها. ويؤدي هذا الاستنتاج إلى تهميش التحقيقات الصوتية والدلالية، ويؤكّد أولوية نظرية المعرفة التفسيرية على النظرية الاسمية.
وواصل تحليله قائلًا: يعالج أفلاطون اللغة بوصفها مسألة ثانوية متفرعة عن مشكلة المعرفة، التي يُعدّها القضية الأكثر أهمية. فالمعرفة الحقيقية، في نظره، هي معرفة "المُثُل". وتُعَد العلاقة بين المُثُل والجزئيات، ومحاولة إيجاد حدٍّ فاصل أو وسيط بينهما، من أعقد القضايا في فلسفته. ويبدو أنه يرى – في بعض الأحيان – أن اللغة تمثّل وسيطًا بين المُثُل والجزئيات، إذ إن الكلمات تُشبه المُثُل من جهة، وتشبه الجزئيات من جهة أخرى، وبذلك يمكن، من خلال الكلمات، الوصول إلى معرفة المُثُل انطلاقًا من تأمل الجزئيات.
إن القارئ الذي يتصفّح هذا الكتاب لا يطالع ترجمةً فحسب، بل يعانق أدبًا مترجَمًا بإخلاص ووعي، حيث تبدو كل جملة مصقولة من كل ركاكة، ومنقاة من شوائب الترجمة الحرفية. وهنا تتجلى عبقرية المترجم؛ إذ لم يكن مجرد ناقل للنص، بل كان قارئًا فطنًا، وناقدًا بصيرًا، وكاتبًا متمكنًا، التقط ظلال المعاني، وأعاد بثّها على الورق بلغةٍ عربية أصيلة، لا تنحني للغربة، ولا تتكلف في البيان.
وختامًا، نجد أن عمل الدكتور محمد الكيلاني في كشف النقاب عن إحدى محاورات أفلاطون الهامة، يؤكد أن هذه الترجمة ليست مجرد جسرٍ بين لغتين، بل هي بناءٌ متين، أُقيم على فهمٍ عميقٍ للنص، وحسٍّ أدبيٍّ راقٍ، وإخلاصٍ للغة الضاد. إنها تذكيرٌ نادرٌ بأن الترجمة الحقة ليست صنعةً فحسب، بل فنٌّ ومسؤولية، وأن المترجم، حين يُتقن أدواته ويصدق في سعيه، لا ينقل النصوص فقط، بل يهبها حياةً جديدةً في موطنٍ جديد.
[email protected]